حول حجية خبر الواحد في العقائد
الشيخ حسين الخشن
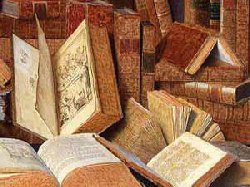
لقد تسالم المسلمون على تعريف وتقديم الإسلام بأنه عقيدة وشريعة، والعقيدة تمثل البناء الفكري والنظري للإسلام، بينما تمثل الشريعة السلوك العملي، والبناء النظري يرتكز على إذعان القلب وقناعة العقل والفكر، من هنا كان الدين غير قابل للاكراه {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي}(البقرة:256)، فإنّ الاعتقاد والاقتناع من أفعال القلوب والجوانح وهي لا تقبل الاكراه والاجبار، خلافاً للسلوك العملي فلا يتوقف على الاذعان لارتباطه بالجوارح وهي تقبل التعبد بل والإكراه.
الإسلام تصديق بالجنان وعمل الأركان:
ولذا نرى المؤمن المعتقد بالله ورسوله واليوم الاخر قد يقوم ببعض الأعمال العبادية أو غيرها مما جاءت به الشريعة حتى لو لم يفهمها، أو وصلت إليه بالطرق الظنية، لأن اذعانه وتسليمه لله ولرسوله وإيمانه بحكمته وعلمه تعالى يدفعه للالتزام والتعبد العملي بما نصّت عليه الشريعة، وبعبارة أخرى: إن أمر الاعتقاد والاذعان ليس بيد الإنسان فلا يمكنه أن يكره نفسه على الاذعان بشيء إن لم يملك هذا الشيء من عناصر الاقناع ما يوجب الاعتقاد، وأما السلوك العملي فهو أمر اختياري وخاضع لارادة الإنسان فيمكن إكراهه عليه كما بإمكانه أن يكره نفسه على الانقياد العملي ولو في حالة الشك بالشيء أو عدم فهم فلسفته.
وقد أشارت الأحاديث إلى هذا الفارق ففي الحديث عن الإمام الرضا (ع) عن ابائه عن أمير المؤمنين (ع) قال سمعت رسول الله (ص) يقول:" الإيمان: قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالاركان" (الأمالي للطوسي448)، وفي حديث اخر عن الإمام الصادق(ع) : "الإيمان: قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالاركان" (دعائم الإسلام 3/1)، وفي حديث اخر عن الإمام الرضا(ع): "الإيمان عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل بالاركان" (عيون أخبار الرضا(ع)205/2)، فإن العقد بالقلب أو المعرفة القلبية أو التصديق بالجنان تشير إلى معنى واحد وهو الوظيفة الاعتقادية للإيمان، بينما يشير العمل بالاركان إلى الوظيفة السلوكية، وأما النطق باللسان فهو يرمز إلى الإسلام الرسمي باعتبار النطق علامةعلى الانتساب إلى الإسلام.
عدم حجية الظن في العقائد:
إن هذا الفارق الجوهري بين الإيمان الاعتقادي والإيمان السلوكي هو الذي يفسر ويبرر الاجماع الإسلامي حول عدم حجية الظن في أصول العقيدة، فإن الاعتقاد يتطلب إذعاناً وتصديقاً قلبياً، والظن لا يورث إذعاناً للقب ولا قناعة للعقل، وعلى ضوء ذلك فإن القدرالمتيقن من الايات الناهية عن اتباع الظن كقوله تعالى:{إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون}(الأنعام:116)، أو قوله سبحانه:{وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً}(يونس:36)، هو الظن في المجال العقائدي، أما في الحقل التشريعي فإن عدم حجية الظن لا تزال غير محسومة بل تخضع للكثير من الجدل على الأقل في بعض وسائل الاثبات الظنية كالقياس أو الاستحسان أو غير ذلك.
إن عدم حجية الظن في القضايا الاعتقادية لا يفرق فيها بين الأصول التي تجب فيها المعرف التفصيلية كالأصول الخمسة المشهورة، أو فروع العقيدة مما لا يشترط فيها المعرفة التفصيلية بل يكفي الإيمان فيها على ماهي عليه، فالجميع يحتاج إلى عقد القلب وتصديق الجنان مما لا يتوفر بالطرق الظنية.
خبر الواحد بين الفقه والعقائد:
وفي هذا السياق فقد ذهب مشهور العلماء إلى التفصيل في حجية الخبر بين المجال التشريعي والمجال العقيدي، فقالوا بحجيته في المجال الأول إذا كان رواته ثقاة دون المجال الثاني، لأن خبر الواحد، وإن كان رواته عدولاً لا يفيد في حد ذاته علماً ويقيناً مما يتطلبه الاعتقاد إلا إذا احتف بقرائن خارجية أوجبت حصول العلم واليقين بمضمونه أو بصدوره أو وصل إلى حد التواتر.
ومما يعزز من وجاهة التفصيل المذكور أن الأخبار المرتبطة بالمجال التشريعي خضعت للنقد والغربلة من خلال الجهود التي بذلها الفقهاء والعلماء، بخلاف الأخبار المرتبطة بالشأن العقائدي فإن التساهل إزائها ظل سيد الموقف، مع أنها عرضة للكذب والدس والتزوير أكثر من تلك، بناء على ما هو المعروف أن إحدى دواعي الوضع والكذب قامت على خلفية النزاع الكلامي ومحاولات الانتصار المذهبي. أضف إلى ذلك: أن الخلل في أخبار العقيدة أكثر خطورة من الخلل في الأخبار المرتبطة بالأحكام الشرعية والسلوك الشخصي.
ويمكن مقاربة الاستدلال على التفصيل المذكور من زاوية أخرى مفادها: ان مقتضى القاعدة الثابتة بالبرهان والقران عدم حجية الظن مطلقاً وفي كافة الحقول المعرفية، بيد أن ما دل على حجية خبر الثقة يدفعنا لرفع اليد عن ذاك الإطلاق بخصوص الأخبار الواردة في الحقل التشريعي دون ما هو وارد في المجال العقائدي أو التكويني ، فهذه إذا لم تحتف بالقرائن الموجبة لليقين أو الاطمئان تبقى داخلة في عموم النهي القراني عن اتباع الظن، بل لا معنى للحجية فيها، لأن الحجية لا تعني سوى ترتيب الاثار الشرعية على مضمون الخبر فيما كان له أثر شرعي وهو غير موجود سوى في روايات الأحكام.
وعلى ضوء ذلك فلا يصح الاعتراض على ما ذكرناه بأن ما دل على حجية الخبر كالسيرة العقلائية مثلاً عام وشامل لمطلق الأخبار سواء كان مضمونها تشريعياً أو عقدياً، لأن السيرة المشار إليها لا يحرز قيامها على الأخذ بخبر الثقة في الشؤون العقائدية إلا إذا كان الخبر مفيداً لليقين أو محتفاً بقرائن توجب الاطمئنان. على أن حجية السيرة في المقام رهن بعدم الردع عنها، وما دل على عدم حجية الظن يشكل رادعاً عنها في المجال العقدي على أقل تقدير.
بين الوثوق والوثاقة:
هذا كله لو بنينا على الرأي المشهور في حجية خبر الثقة، بيد أن هناك اتجاهاً اخر اختاره جمع من الاعلام وهو يرى أن الحجية ثابتة للخبر الموثوق لا لخبر الثقة، والفرق بين الاتجاهين: أن الأول يعتمد وثاقة الراوي أساساً في الحجية، فإذا احرزت وثاقته أخذ بالرواية سواء حصل الوثوق بصدورها أو لم يحصل، وأما الاتجاه الثاني: فيرى أن العبرة بحصول الوثوق بالرواية لا بالراوي، فكلما حصل وثوق بصدورها كان ذلك كافياً للأخذ بها ولو لم تحرز وثاقة الرواة، وإذا لم يحصل الوثوق بها كان ذلك كافياً لرفضها حتى لو كان رواتها ثقاة عدولاً.
إنه وبناء على هذا الاتجاه قد لا يبقى ثمة مجال للتفصيل المشار إليه بين "أخبار الفروع" و"أخبار الأصول"، لأن الوثوق والاطمئنان علم عرفي فلا تشمله الايات الناهية عن اتباع الظن، وهو طريق جرى عامة العقلاء على الاعتماد عليه في شتى المجالات سواء العقيدية أو التشريعية أو القضائية أو غيرها. أجل الشأن كل الشأن في تحصيل الوثوق والاطمئنان بصدور الخبر، فإن ذلك رهن توفر عناصر موضوعية تساعد على حصوله ومن أهمها: وثاقة الرواة، وموافقة الخبر للكتاب والمرتكزات العقلائية، وموافقته وعدم منافاته لأحكام العقل ولما عليه جمهور العلماء.
اعتراض مرفوض:
وقد اعترض بعضهم على القول بعدم حجية خبر الواحد في العقائد ما لم يكن مفيداً لليقين أو الاطمئنان، بأن لازمه إلغاء كل حديث النبي (ص) وأهل بيته (ع) والاقتصار على بضعة أحاديث قد لا تتجاوز عدد أصابع اليدين، إذن فعلى الإسلام السلام..(خلفيات 134/2)، إلا أن هذا الاعتراض مجرد تهويل لا يصغى إليه، لأن أمهات القضايا العقدية وبعض تفاصيلها ثابتة بالادلة القطعية العقلية أو النقلية، وليست بحاجة إلى أخبار الاحاد، على أن الروايات التي يمكن تحصيل الوثوق بها ليست بهذه الندرة لينعى الإسلام بهذه الطريقة التهويلية، كيف وقد تبنى جمع من كبار الفقهاء كالمرتضى وابن ادريس وغيرهما موقفاً رافضاً لاعتماد أخبار الاحاد حتى على المستوى الفقهي فضلاً عن العقائدي ومع ذلك لم يلزم خراب الدين ولا تأسيس دين جديد.
نتائج الاعتماد على أخبار الاحاد:
في ضوء ما تقدم من عدم حجية أخبار الاحاد في الحقل العقائدي لا بدّ من تسجيل تحفظنا على ظاهرة التساهل والتسامح الملحوظة في اعتماد الخبر الواحد في مجال الاستنباط العقدي حتى من قبل من يصرّح بعدم حجيته في هذا الحقل، وقد بُني على التسامح المشار إليه الكثير من التصورات والمفاهيم التي تصل إلى حد الغلو ببعض الرموز أو اتخاذ مواقف واراء متشددة ومتشنجة قد تصل إلى حد تكفير الاخر، أو الحكم على أمة كبيرة من الناس بالهلاك والعذاب، كما في مفهوم الفرقة الناجية الذي ينص على هلاك معظم الأمة الإسلامية لمجرد خبر واحد وصحيح السند على أفضل التقادير، ومما يمكن ذكره في هذا السياق ما روي عن رسول الله (ص) بشأن أمه رضي الله عنها قال (ص) :"استأذنت ربي أن استغفره لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي" (صحيح مسلم 671/2)، وفي حديث اخر بشأن والده: أن رجلاً قال يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار، فلما مضى دعاه فقال له: إن أبي وأباك في النار" (صحيح مسلم191/1) إن هذين الحديثين مخالفان لحكم العقل بقبح معاقبة من لم تقم عليه }الحجة، وأهل الجاهلية في معظمهم كذلك فهم من أهل الفترة الذين لم يبعث الله فيهم نبياً حسبما أشارت له الاية الكريمة :{يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل.