"اصالة الصحة" في مواجهة الفكر التكفيري
الشيخ حسين الخشن
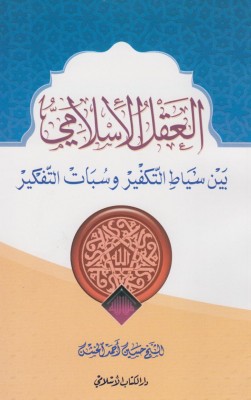
في ظل غلواء فتنة التكفير التي تجتاح العالم الاسلامي برمته من شرقه إلى غربه، حاصدة أرواح آلاف الأبرياء من المسلمين وغيرهم، في تجاوز صريح لكل القيم الإنسانية وانتهاك فاضح لكل الحرمات, وتشويه غير مسبوق لصفاء الصورة الإسلامية والمحمدية، في ظل هذه الفتنة يكون لزاماً على أهل البصيرة والوعي من علماء الأمة ومفكريها أن يقفوا ملياً أمام هذه الظاهرة ويتداعو لدرس مخاطرها، ويستنفروا كافة طاقاتهم وجهودهم الفكرية لمعرفة أسباب انتشارها وسبل معالجتها، وقد تطرقنا لهذا الموضوع في مناسبات عديدة وتحدثنا باسهاب عن مناشىء التفكير ودواعيه، ومنابع الفكر التكفيري، وضوابط حماية المجتمع الاسلامي من فتنته وشره.
قاعدة الصحة:
ما أريد التطرق، له في هذه المقالة هو الإشارة إلى ضابط من الضوابط الإسلامية التي تساهم ـ في حال تثقيف الأمة عليها ـ في حماية المجتمع الإسلامي من التفكك الداخلي، وفي حقن دماء المسلمين التي تُسفك باسم الإسلام وتحت رايته، والإسلام منها بريء براءة الذئب من دم يوسف، وهذا الضابط هو ما يصطلح عليه بـ"أصالة الصحة"، وقد تناولها الفقهاء بالبحث من الزاوية الفقهية، وما نرمي إليه هنا استعراض بعض مجالات القاعدة مما له علاقة بتحصين المجتمع الإسلامي، ورفع كل عناصر التوتر من داخله.
الحمل على الأحسن:
المجال الأول أو البعد الأول لهذه القاعدة: هو البعد الأخلاقي ويراد بالصحة هنا حسن الظن بالآخرين واستبعاد نية السوء في تفسير أقوالهم وأفعالهم، فكل عمل يقوم به الغير وهو يحمل وجهين: أحدهما يمثل القبح والآخر يمثل الحسن، فيحمل فعله على الوجه الحسن ولو كان احتماله ضعيفاً ويستبعد احتمال السوء ولو كان قوياً، وهذا ما يستفاد من دعوة القرآن الكريم إلى اجتناب الظن السيء بالآخر، قال تعالى :( يا أيها الذين اجتبنوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم..)، وهذا ما يرمي إليه وبوضوح الحديث المروي عن رسول الله (ص): "اطلب لأخيك عذراً فإن لم تجد له عذراً فالتمس له عذراً"، وكذلك الحديث المروي عن أمير المؤمنين(ع):" ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً"(الكافي:2/392).
إن حمل الآخر المسلم على الأحسن لايراد به بناء الشخصية الساذجة التي تفقد المؤمن فطنته وكياسته بل يهدف إلى إزالة عوامل التوتر الداخلي وخلق مناخات الثقة بين المؤمنين لأن سوء الظن إذا ما فتك بالمجتمع فإنه يفكك عرى الأخوة ويضعف المناعة الداخلية بما يهدد بانهيار المجتمع برمته.
وهذا البعد الأخلاقي للقاعدة إنما يرمي ـ كما عرفت ـ إلى استبعاد ظن السوء، ولكنه لا يرمي إلى ترتيب الآثار الشرعية للصحة، فلو أن شخصاً مرّ بجمع من الناس وتلفظ بكلام دار أمره بين أن يكون سباباً أو سلاماً، فالحمل على الأحسن يقتضي استبعاد احتمال السباب دون أن يعني ذلك الحكم بكون الصادر منه هو السلام، وبالتالي يجب رد السلام أو التحية بمثلها، وان كان ذلك مستحسناً ويعكس خلقاً متسامياً.
الصحة المعاملاتية:
المجال الثاني لقاعدة الصحة: هو مجال المعاملات والعقود كالبيع والاجارة، وكذلك الزواج والطلاق وغير ذلك، فلو شك في صحة زواج فلان واستجماعه للشرائط يُبنى على الصحة ويتم ترتيب آثارها إلا إذا ثبت الفساد.. ولو احتمل أن شراء فلان لبيته أو مزرعته كان في إطار عقد فاسد يُبنى على الصحة أيضاً ويُحكم تالياً بجواز الشراء منه وهكذا... والمدرك الأساسي لقاعدة الصحة في بعدها المعاملاتي هو سيرة العقلاء على اختلاف مللهم ونحلهم، بل لو لم تكن هذه القاعدة معتبرة لأوجب ذلك اختلال النظام.
والفارق بين الصحة في المجال الأخلاقي والمجال المعاملاتي، أن الصحيح في المجال الأول يقع في مقابل القبيح، بينما في المجال الثاني يقع الصحيح في مقابل الفاسد.
الصحة في الأعتقاد:
المجال الثالث: هو المجال الاعتقادي، فهل يمكن الحمل على الصحة في الاعتقادات ؟ فلو شك أن عقيدة فلان ممن هو على ظاهر الإسلام صحيحة أم فاسدة؟ وأنه مؤمن فعلاً بالله وأن محمداً رسوله وأن العباد يبعثون ويحشرون أو أنه لا يؤمن بذلك كله أو بعضه فماذا يحكم عليه؟
ولا بد من الالفات أن الحكم بفساد العقيدة له مخاطر جمة ومضاعفات خطيرة، لأن هذا الحكم قد يستبتع حكماً بارتداده واهدار دمه أو حكماً بضلاله وانحرافه وهو ما قد يؤدي إلى محاصرته وعزله اجتماعياً، كما أن للحكم بفساد العقيدة آثاراً شرعية كثيرة سواء على مستوى الأحوال الشخصية كالزواج أو الميراث أو على المستويات الأخرى كتوليه بعض المناصب والمهام كالامامة والشهادة ونحو ذلك.
والظاهر أنه لا مجال إلا للحمل على الصحة في هذه الحالة ما دام الشخص على ظاهر الإسلام ولم يظهر منه ما ينافي ذلك قولاً أو فعلاً. وقد جرت سيرة المسلمين على تصحيح اعتقاد من يدعي الإسلام حتى يعلم الخلاف، ولا يطالب ببرهان يثبت إسلامه(القواعد الفقهية للبجنوردي 1/311)، وقد ذهب بعض الاعلام إلى جواز الحكم "بإسلام كل من شك في إسلامه وإن لم يدّع الإسلام إذا كان في دار الإيمان، والوجه في ذلك: استقرار سيرة المسلمين على إجراء أحكام الإسلام على كل من كان في بلاد الإسلام من دون فحص عن مذهبه حتى يقوم دليل على فساده"(القواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي1/155)، والمرجح أن نظره إلى صورة كثرة المسلمين من الناحية العددية في بلد ما، وأما البلاد المختلطة إلى حد المناصفة أو ما هو قريب من ذلك فيشكل الأمر في البناء على إسلام من يشك في إسلامه فيها، والسيرة المشار إليها لم تجر على ذلك.
وعلى ضوء ما تقدم لو أن شخصاً ذبح حيواناً مأكول اللحم وشكينا في حلية الأكل بسبب شكنا في صحة اعتقاد الذابح، فعلينا الحكم بحلية الأكل ما دام الذابح على ظاهر الإسلام أو ادعي ذلك ويحمل اعتقاده على الصحة ولا يلزم الفحص عن تفاصيل معتقده أو اختباره بالسؤال ونحوه.
محاكمة العقائد:
ومما يؤسف له أن بعض الناس من أنصاف المتفقهين ينصبون أنفسهم مفتشين عن عقائد الناس ويصدرون الأحكام يميناً وشمالاً تكفيراً وتضليلاً أو تفسيقاً وتبديعاً، دون تثبت أو تورع، مع أن تكفير المسلم أو تضليله أمر عظيم عند الله ولا يجوز اقتحام هذه العقبة إلا بحجة دامغة تقطع الشك باليقين، فلو أن كاتباً أو محاضراً طرح بعض الأفكار التي قد يتراءى منها التشكيك في بعض المسلمات العقائدية لكن لها وجهاً حسناً ومحملاً صحيحاً لا ينافي الاعتقاد فلا يسوغ البناء على الاحتمال الفاسد والحكم على أساسه، فإن اليقين لا يزال إلا بيقين مثله، والحدود تدرأ بالشبهات، وصريح القرآن يقول: (ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمناً..) (النساء:94), في تأكيد بيّن على مبدأ الأخذ بالظاهر والابتعاد عن محاكمة النوايا التي لا يعلمها الا الله العالم بالسرائر.
ولنعم ما قاله الملا علي القاري"الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف أن لا نكفر أهل البدع الا إذا أتوا بكفر صريح لا استلزامي، لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بمذهب ومن ثم لا يزال المسلون يعاملونهم معاملة المسلمينِ".