التكفيريون بين الانشغال بالهوامش وسرعة الانفعال
الشيخ حسين الخشن
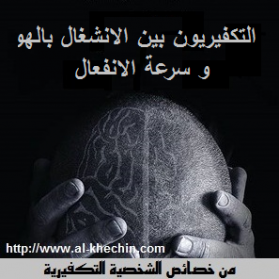
التكفيريون بين الانشغال بالهوامش وسرعة الانفعال
الانشغال بالهوامش
السّمة الثانية التي تميّز الشخصيّة التكفيرية- بعد صفة الغرور الديني– أنّها تستغرق في الصغائر وتنشغل في التفاصيل وتخوض الكثير من المعارك الجانبية والهامشية، وهذا الأمر ناتج عن افتقادها الميزان الصحيح في تشخيص الأمور وتحديد الأولويات، ولذا نرى أتباع هذه الجماعات يُكثرون الجدال والسؤال والقيل والقال في توافه الأمور ونوافلها على حساب القضايا الكبرى في العقيدة والشريعة والحياة.
مع أنّ القرآن الكريم رسم لنا منهجاً واضحاً، ودعانا إلى تجنّب الخوض في الصغائر والهوامش والتركيز على المتون والأصول النافعة في الدنيا والآخرة، وهذا ما نلحظه بوضوح في قصة أهل الكهف، وما حكاه لنا الله تعالى عن اختلاف الناس في عددهم قال عزّ من قائل: {سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} ويأتي التوجيه الإلهي بضرورة تجنّب هذا النوع من الجدال لعدم جدواه {قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاهِراً وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَداً}[الكهف: 22].
وهكذا يلاحظ المتأمّل والمتتبّع لظاهرة السؤال في القرآن (يسألونك- يسألك– وإذا سألك..)، أنّ الله سبحانه يوجّه عباده في بعض الحالات إلى ترك السؤال عن بعض الأشياء ممّا يكون الخوض فيها مضرّاً أو غير ذي جدوى، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}[المائدة: 101]، أو أنّ ذلك ممّا لا يتّصل بمسؤوليّاتهم {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ}[الأعراف: 187].
النبي وترشيد أسئلة الأمة
وفي حالات أخرى نجد أنّ الله تعالى يدعو رسوله إلى ضرورة ترشيد أسئلة الأُمة وذلك من خلال الإجابة على أسئلتهم بجواب لا يتطابق مع السؤال، تنبيهاً لهم إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه، كما في قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}[البقرة: 189]، فقد كان سؤالهم- كما يظهر من الآية وتؤكّده أسباب النزول- عن حالات اختلاف القمر، فإنّه يبدو صغيراً ثم يكبر ثم يصغر بعد ذلك، فأرادوا أن يفهموا سرّ ذلك، لكن الجواب لم يكن على وفق السؤال، بل اتّجه اتجاهاً آخر وهو الحديث عن فوائد هذا الاختلاف بين منازل القمر، لأنّه يحدّد للناس مواقيتهم ومواعيدهم فيما يحتاجون إليه من تحديد الوقت في قضاياهم العامة والخاصة"[1]، على أنّهم لم يكونوا في المستوى الذي يؤهّلهم للاستفادة من المعرفة الفلكية، ما يجعل الدخول معهم في ذلك غير ذي جدوى، بل إقحاماً لهم في عملية لا تتّسع لها أفكارهم وعقولهم.
ويتكرّر نفس الأسلوب والمنهج في قوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [البقرة: 215]، حيث نلاحظ أنّ الجواب اتجه بعيداً عن النص الحرفي للسؤال، ترشيداً وتوجيهاً للناس إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه، ولذا وبدل أن يجيبهم بالتفصيل عما يلزمهم الإنفاق منه، وهو مورد سؤالهم، فإنّه مرّ على ذلك مرور الكرام بعبارة موجزة "ما أنفقتم من خير" من دون أن يدخل في تفاصيل هذا الخير، لأنّ إنفاق الخير جيّد على كلِّ حال، لكنّه توقّف مليّاً عند مَنْ ينبغي الإنفاق عليهم، مع أنّ ذلك لم يكن مورداً للسؤال، ليبين لهم أنّ هذا هو المهم، فليس مهماً نوع الإنفاق ما دام خيراً ونافعاً، بل المهم أن تعرف أين تضع مالك وأين تُنْفقه؟
هذا هو منهج القرآن، فأين المسلمون لاسيّما الجماعات التكفيرية منه؟!
إنّنا عندما نلاحظ إقدامهم على عظائم الأمور وتَوَقُّفهم وتورّعهم في الصغائر، نستذكر موقف البعض من أهالي الكوفة، ممّن تجرأوا على قتل الحسين (ع) وانتهاك حرمته ثم جاؤوا يستفتون في حكم قتل البعوض والذباب.
فقد رُوِي أنّ رجلاً سأل ابن عمر عن دم البعوض، فقال: ممّن أنت؟ فقال: من أهل العراق، فقال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبيّ (ص)! وسمعت النبي (ص) يقول: "هما ريحانتاي من الدنيا"، ورُوِيَ أنّه سأله عن المُحْرِم يقتل الذباب؟ فقال: "يا أهل العراق تسألوني عن قتل الذباب وقد قتلتم ابن رسول الله (ص)!"[2].
سرعة الانفعال
السمة الثالثة للشخصيّة التكفيرية أنّها شخصية انفعالية ارتجالية سريعة الغضب حادّة المزاج كثيرة العثار والاعتذار، وسرعة الغضب هي من علامات الجاهل، قال عليّ (ع): "من طبائع الجهّال التسرّع إلى الغضب في كلّ حال"[3].
وفي سبيل الحدّ من سلبيّات الغضب والانفعال وآثارهما المدمّرة، نعرض لما جاء في النصوص الإسلامية من حديث عن حقيقة الغضب وآثاره السلبية على المستوى الشخصي والاجتماعي والديني، وعن سبل معالجته والتخلُّص منه.
حقيقة الغضب
الغضب نار تستعرّ داخل الإنسان، وهي إن لم يطوّقها أحرقته وأحرقت كلّ مَنْ حوله، في الحديث عن رسول الله (ص): "الغضب جمرة توُقَد في جوف ابن آدم، ألم تروا حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه..."[4] وعن عليّ (ع) "الغضب نار القلوب" وفي حديث آخر عنه (ع): "الغضب عدوٌ فلا تملّكه نفسك" وتصل حدّة الغضب إلى درجة الجنون وخروج صاحبه عن حدّ الإنسانية، يقول علي (ع) فيما رُوِي عنه: "الحدَّة ضرب من الجنون لأنّ صاحبها يندم فإنْ لم يندم فجنونه مستحكم"، وفي حديث آخر عنه (ع): "مَن غلب عليه غضبه وشهوته فهو في حيّز البهائم"[5].
آثار الغضب
وأمّا عن آثار الغضب وسلبيّاته، فإنّه:
أولاً: يُحرق أعصاب صاحبه ويوتّرها ويُوقعه في المهالك، قال الإمام علي (ع) فيما يُروى عنه: "الغضب يُرْدِي صاحبه ويُبْدي معايبه"، وعنه (ع): "الغضب نار موقدة، مَنْ كظمه أطفأها ومَنْ أطلقه كان أول محترق بها"، ومن جوامع كلماته المروية عنه في هذا الشأن: "سبب العطب طاعة الغضب"، وهكذا تكون نهاية الشخص الذي يتملّكه الغضب، الندم والاعتذار، فعنه (ع): "إيّاك والغضب فأوّله جنون وآخره ندم"، وينبّه الإمام (ع) الشخص الانفعالي إلى أن نشوة الغضب يقابلها ذلّ الاعتذار يقول (ع) كما في الرواية "لا يقوم عزّ الغضب بذلّ الاعتذار"[6].
وثانياً: إنّ الانفعال يدفع صاحبه إلى اطلاق الكلمات اللامسؤولة، واتّخاذ المواقف الارتجالية دون وعي ولا إدراك، فتراه يشتم ويكفّر ويعتدي ويضرب ويدمّر ويقتل..
ولذا ركّزت وصايا النبيّ (ص) وأهل بيته على عدم الانسياق وراء الغضب، قال عليّ (ع) فيما رُوِيَ عنه "إذا أبغضت فلا تهجر"[7]، وعن الإمام الصادق (ع): "سمعت أبي يقول: أتى رسولَ الله رجلٌ بدويٌّ فقال إنّي أسكن البادية فعلّمني جوامع الكلام، فقال: آمرك أن لا تغضب... وكان أبي يقول: أي شيء أشدّ من الغضب إنّ الرجل ليغضب فيقتل النفس التي حرّم الله ويقذف المحصنة"[8].
وثالثاً: إنّ عاقبة الغضب والانفعال الخطيرة أنّه يُفسد الإيمان ويعرّض الإنسان لسخط الله، فعن الإمام الصادق (ص): "قال رسول الله: "الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخلّ العسل" وعن الباقر (ع): "إنّ الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى يدخل النار"[9].
سُبُل معالجته
إنّ أهمّ دواء لمعالجة داء الغضب هو الاستعانة بالحِلْم والصبر وإيقاظ مشاعر الإيمان لدى الإنسان وإعمال ضوابط العقل وكوابحه، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ}[الشورى: 37] وعن النبي الأكرم (ص): "ليس الشديد بالصُّرَعة إنّما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"[10] وعن أمير المؤمنين (ع): "إذا تسلّط عليك الغضب فاغلبه بالحلم والوقار"، وفي كلمة أخرى له (ع): "إن كان في الغضب الانتصار، ففي الحلم ثواب الأبرار"[11].
وهكذا يوصي النبي (ص) باعتماد علاجٍ نفسيّ وتربويّ لحالة الغضب، وهو أن يتحرّك الإنسان الغاضب وينشغل بأمر آخر ولا يبقى مستغرقاً في القضية التي أغضبته، قال (ص) في تتمّة الحديث الآنف: "فإذا وجد أحدكم من ذلك (الغضب) شيئاً فليلزق بالأرض ألا إنّ خير الرجال مَنْ كان بطيء الغضب سريع الفيء، وشرُّ الرجال مَنْ كان سريع الغضب بطيء الفيء.."[12] وعن الإمام الباقر (ع): ".. فأيّما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنّه سُيذهب عنه رجس الشيطان، وأيّ رجل غضب على ذي رحم فليدنُ منه فليمسّه فإنّ الرحم إذا مُسَّت سكنت"[13].
من كتاب العقل التكفيري قراءة في المنهج الاقصائي
4/3/2014
[1] من وحي القرآن، السيد فضل الله (رض) ج4 ص66-67، دار الملاك- بيروت، ط2.
[3]تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ص302.
[4]المستدرك للحاكم ج4 ص506.
[5] راجع هذه الأحاديث في كتاب: تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ص301-302.
[10] صحيح البخاري ج7 ص100.
[11] تصنيف غرر الحكم 302.