البعد الإنساني في شخصية الإمام علي (ع)
الشيخ حسين الخشن
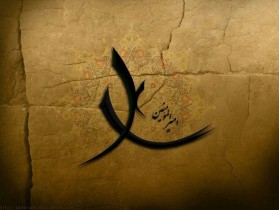
البعد الإنساني في شخصية الإمام علي (ع)
في ذكرى مولده هل لنا أن نتطلع إلى علي (ع) من منظار علي نفسه لا من منظارنا نحن، لنعرف علياً(ع) كما يريد وكما كان، لا كما نريده نحن أو نحب أن يكون ؟ فإن مشكلتنا ومشكلة الكثيرين من الناس أننا نبني تصورات ورؤى خاصة حول الشخصيات والرموز التاريخية على قياسنا وكما نحلم أن تكون تلك الشخصيات، ومن هنا فقد تجد هذا التفاوت أو التنافر في الصورة، حيث ترتفع تارة وتهبط أخرى، تبعاً لذهنية الشخص الذي حاك تلك الصورة أونسجها، وهذا ما قد يفسر لنا تلك المبالغات أو المغالاة التي قد ترفع الشخصية عن مسستواها البشري تارة، أو تحط من قدرها تارة أخرى.
الشخصية المتكاملة
وإننا عندما ننظر إلى علي بهذا المنظار، وهو المنظار الأقرب إلى الواقع وعندما نحدق بتلك الشخصية التي تخرجت من مدرسة الإسلام وتربت على يدي رسول الله (ص) ونتأمل في مزاياها وخصائصها سنجد أنفسنا أمام شخصية استثنائية قلّ أن تتكرر أو يجود الزمان بها، شخصية متعددة الأبعاد ومتكاملة الصفات، فهو مجمع الفضائل الإنسانية، ومصدر ملهم لكل الأحرار، وقد أجاد الصفي الحلي في التعبير عن هذا جامعية علي (ع) للصفات التي تبدو متضادة فيما بينها وقلّ أن تجتمع في رجل، يقول في بيان هذا المعنى:
جمعت في صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد
زاهد حاكم حليم شجاع ناسك فاتك فقير جواد
شيم ما جمعن في بشر قط ولا حاز منهم العباد
خلق يخجل النسيم من اللطف وبأس يذوب منه الجماد
تغليب البعدين البطولي والمعاجزي
لكن ما يؤسف له أنّنا وعندما نظرنا إلى علي من منظارنا نحن فقد قزّمنا أو مسخنا شخصيته، وقدمنا عنه صورة مشوهة، لأن من تتحكم به رؤية خاصة عن علي (ع) فمن الطبيعي أن لا يعمل على استحضار شخصيته كما هي عليه في كافة أبعادها، بل سوف يتمّ اجتزاؤها وتغليب بعض الأبعاد وإغفال أبعاد أخرى، وهكذا كان فقد تم اختصار شخصيته ببعدين أساسيين:
1- ويأتي البعد البطولي في شخصية الإمام على رأس تلك الابعاد التي يتم استحضارها من خلالها، حيث يتمّ التركيز على بطولته(ع) وفروسيته في المعارك، وترانا في أشعارنا وأدبياتنا نتغنى كثيراً في كيفية قتله للأبطال وفي عدد الذين صرعهم بسيفه، أليس هذا ما يغلب استحضاره من علي (ع) في خطابنا وتعبيراتنا العاطفية، ولذا ترانا نعبّر عن حبنا للإمام (ع) برفع سيف يرمز إلى ذي الفقار نعلقه في صدورنا أو بيوتنا أو ما إلى ذلك، ولا شك أن علياً (ع) كان من أشجع الناس وأمضاهم بأساً وعزيمة، ولكن هل هذا هو كل شيء في علي (ع) ؟ أو قل: هل هذا أهم شيء في علي(ع) ؟ وماذا عن سائر خصاله؟ ومن أين استمد علياً هذه الشجاعة ؟
ولعل السر في التركيز على هذا الجانب البطولي من شخصية الرمز واستحضاره بطريقة تغيب معها الأبعاد الأخرى من شخصيته هو أنّ الأمة المهزومة والجماعة المظلومة والضطهدة تستدعي من شخصياتها التاريخية ورموزها المقدسة الجانب الذي يعوّض النقص لديها، وهذه قضية نفسية عامة، فعند يجد الكثيرون واقعهم مهزوماً يلذون بماضيهم، ويعودون إلى الأطلال وذكرى الآباء والأجداد.
على أنّ العرب - وربما غيرهم - شعب يستهويهم - وبحسب ثقافتهم وعاداتهم - البعد البطولي والرجولي في الشخص ولا سيما القائد، ولذلك ترى اليوم الكثيرين يرمزون إلى علاقتهم بالإمام علي (ع) بالسيف الذي يعلق في أعناقهم! وهذا الأمر أدى إلى نتائج سلبية كحصول شيء من المبالغات في صفة الشجاعة لدى الإمام علي (ع)، مع أنّ شجاعته لا تحتاج إلى دلائل، وأخطر ما في الأمر هو أن تطلب الجانب البطولي بمعناه الجسدي غيب ما هو أهم وهو جانب البطولة الفكرية إن صح التعبير، وهكذاغابت الأبعاد الأخرى.
2- والبعد الآخر في شخصية الإمام (ع) الذي يتم تغليبه واستحضاره أكثر من غيره هو البعد المعاجزي والفضائلي، حيث كثيراً ما يتم التركيز على هذا الجانب في خطابنا، ولطالما ألّفت الكتب حول معاجز الإمام(ع) وكراماته وفضائله، ولا شك أنّ لعلي(ع) من الفضائل والكرامات الشيء الكثير، وهذا الجانب لا يصح تغييبه فهو جزء مهمّ من صورة الإمام (ع).
بيد أنّ ذلك لا يختصر تلك الشخصية الريادية، فهناك جوانب وأبعاد أخرى أكثر أهمية لا يجوز تغييبها أو إغفالها، ومن أهمّ تلك الأبعاد البعد الإنساني في شخصية الإمام(ع)، فعلي (ع) في عطائه الفكري هو ملهم للإنسانية جمعاء، وفي سلوكه الأخلاقي والعملي جسد أنبل القيم الإنسانية، ولهذا فهو – بحق – ملك الإنسانية وليس ملكا للمسلمين أو الشيعة، وقد أجاد بولس سلامة في التعبير عن هذا المعنى:
هو فخر التاريخ لا فخر شعب يصطفيه ويدعيه ولياً
لا تقل شيعة هواة علي إنّ في كل منصف شيعياً
إنّما الشمس للنواظر عيد كل طرف يرى الشعاع السنيّا.
كيفية تكوين الرؤية
ولتكوين رؤية واضحة حول المنهج الإنساني في شخصية الإمام علي (ع) يتحتم علينا:
أولاً: التعرف على العناصر التي كونت وساهمت في بناء الشخصية، وهنا لا ننسى أنّ علياً (ع) هو ربيب القرآن وهو الرسالة العالمية والإنسانية الخالدة، كما أنه تلميذ محمد بن عبد الله (ص) وهو الرسول المبعوث للناس جميعاً {وما أرسلناك إلاّ كافة للناس بشيراً ونذيراً} [ سبأ 28].
ثانياً: دراسة حياة هذه الشخصية وسيرته العمليّة، لأنّ قيمة علي (ع) في كل مشروعه ورسالته الإنسانية أنّه لم يكن منظراً تجريدياً، ليتحدث – مثلاً - عن الزهد وهو يعيش الترف، أو ليتحدث عن الخُلقْ الحسن وهو لا يحمل شيئاً من ذلك، أو ليتحدث عن العدالة وهو لا يطبقها.. كلا فعلي (ع) لم يكن كذلك.. بل كان التجسيد الحي للأخلاق الإسلامية المتسامية، من الشهامة، والحلم، والكرم والعفو عند المقدرة، إلى الزهد، والانتصار للمظلوم بفكره ولسانه ويده، ومن الواضح أنّه لا معنى للحديث عن "قائد إنساني" إن لم يكن يحمل من الخصال والخصائص الشخصيّة التي تجعله بحجم الإنسانية.
ثالثاً: النتاج الفكري لهذه الشخصية المعصومة والمتسامية، وهنا تتبدى معادن الرجال وكما قال علي (ع) "تكلموا تعرفوا"، "المرء مخبوء تحت لسانه"، "قيمة كل امرئ ما يحسنه"(نهج البلاغة)، فليس كل إنسان صالح في نفسه يستطيع أن يكون مصلحاً، وليس كل مجاهد يستطيع أن يكون ملهماً، لقد اختزن علي (ع) في شخصيته كل عناصر الجمال والكمال والسمو ما جعله ملهماً للإنسان.
جاذبية الإمام علي (ع)
لا شك أنّ غزارة علي (ع) في علمه وسموّه الفكري والأخلاقي قد فرض له هذا الحضور الإنساني، وأعطاه هذه الجاذبية المنقطعة النظير، والنور بطبيعته يجتذب إليه كل من أضناه الظلام، والماء يجتذب العطاشى إلى مشرعته، ولذلك لما سئل المتنبي عن سبب تركه مدح علي (ع) قال:
وتركت مدحي الوصي تعمداً إذ كان نوراً مستطيلاً شاملاً
وإذا استطال الشيء أمام نفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً
ويؤسفك أن تقول: إنّ الآخرين ربما اكتشفوا هذا البعد الإنساني في شخصية علي (ع) قبل أن يكتشفه المسلمون، ويؤسفك – أيضاً- وبشكل مضاعف أن تعرف أننا – كأتباع لعلي (ع)- لم نساهم في هذه العالمية عند علي (ع)، أو في التعريف بهذا البعد الإنساني الذي أدخل علياً (ع) في الكثير من الآفاق الواسعة، بل ربما شكّل خطابنا عن علي (ع) وتقديمنا له عائقاً أمام تكريس علي (ع) قائداً متربعاً على عرش الإنسانية.
إننا عندما نتحدث عن علي (ع) الإنساني فلسنا نتحدث شعراً ولا عاطفة بل نتحدث من خلال رصد شامل لكل مواقفه وكلماته على الصعيد الإنساني، وهذا الرصد يظهر لنا بكل وضوح أنّ علياً(ع) كان: الرسالي الإنساني، والحاكم الإنساني والحكيم الإنساني، والمشرع الإنساني، والمحارب الإنساني، والمصلح الإنساني..
المصلح الإنساني
وإذا كان المقام لا يسعنا للإسهاب في كل هذه الأبعاد فإننا سوف نقصر الحديث في هذه المحاضرة على البعد الإصلاحي في شخصية علي (ع)، ودعونا نستمع إليه وهو يتحدث عن المهمة الإصلاحية، يقول عليه السلام:
"اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيئ من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلمون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك، اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب ولم يسبقني إلا رسول الله بالصلاة".(نهج البلاغة )
إنّ الإصلاح ليس مهمة سهلة، والطريق أمام المصلحين ليست مفروشة بالورود، بل إنها بكل تأكيد طريق ذات الشوكة، طريق الصعاب والتحديات، ومن هنا كان من الضروري أن يتحلى المصلح الديني والاجتماعي بجملة مواصفات، ومن أهمها صفة الشجاعة، إنّه يحتاج إلى شجاعة النطق بالحق ومواجهة الانحراف، لأنّ نهج الإصلاح ومتطلباته سوف يجعله في مواجهة مع حراس الجهل والتخلف، ومن الطبيعي أن يقف في وجهه كل المتضررين ليعملوا على تقويض مشروعه ووضع العراقيل أمامه، لذا فإنّ كل من يريد التغيير والاصلاح لا بدّ أن يوطن نفسه على الفداء والتضحية.
ومن هنا تعرف لماذا كثر خصوم علي(ع) ومناوؤه، وكما قال: " فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى ومرق آخرون". (نهج البلاغة ، الخطبة الشقشقية )
الاصلاح والحاجة إليه
إنّ الإصلاح حاجة إنسانية مستمرة، وذلك لأنّ الإنسان بطبيعته قد يسقط أمام ضغط الشهوات والمصالح، وينحرف عن خط الفطرة وتتشوه لديه قوة العقل الفطري، لذا كان بحاجة مستمرة إلى عمليّة تهذيب وإصلاح للنفس وتصحيح للمفاهيم والأفكار، ومن هنا كان الأنبياء(ع) هم الذين اضطلعوا بهذه المهمة، فالاصلاح مهمة الأنبياء والرسل(ع)، قال تعالى حاكياً عن لسان شعيب (ع): "إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله"[ هود 88].
ومن هنا وجدنا أنّ أمير المؤمنين(ع) قد أكّد في كلامه المتقدم على مركزية الاصلاح ومحوريته، "ونظهر الاصلاح في بلادك" .
وهكذا رفع الإمام الحسين(ع) شعار الاصلاح في أمة جده بعد وفاة النبي(ص) بنصف قرن تقريباً، فقال فيما روي عنه:" إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي ووالدي".( مناقب آل أبي طالب ج 3 ص 241)
الإصلاح في خطين
والإصلاح لا يصل إلى غايته التغييرية إذا لم يتحرك على خطين متوازيين:
1- إصلاح النفوس، بتهذيبها وتزكيتها، لأن إصلاح المجتمعات وإصلاح الإنسان لا يمكن بغير التربية والتهذيب، ولذا كانت مهمة التزكية واحدة من مهام الأنبياء وأشرفها، كما قال تعالى في وصف النبي الأكرم (ص):{ويزكيكم ويعلمهم الكتاب والحكمة.}[ الجمعة 2] ، وكما قال النبي (ص) مخاطباً علياً (ع): "يا علي لئن يهدي بك الله رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس"،( السنن الكبرى للنسائي ج5 ص 46)، وقد بذل الإمام(ع) جهوداً جليلة في هذا السبيل فعمل على تربية جيل طليعي من خيرة المسلمين
2- إصلاح النصوص، ونريد به تصحيح الانحراف الواقع في خط الرسالات السماوية وفي رسالة الأنبياء، وهو الداء الذي ابتليت به كل الرسالات، من خلال التأويل والتحريف والتزوير الذي يلبس في كثير من الأحيان لبوس الدين، بحيث تتم مواجهة الدين بالدين.
وقد اضطلع علي(ع) بهذه المهمة وقام بها على أحسن وجه وإن كلفه ذلك الكثير من الأعداء، وقد أشار النبي(ص) إلى دور علي(ع) في إصلاح النصوص في قوله(ص): "إنّ منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله، فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله قال: لا ولكن هو ذلكم خاصف النعل" ( شرح الأخبار للنعماني ج 1 ص 321) ، وإنّ معركة التأويل أخطر بكثير من معركة التنزيل.
وفد قال عمار بن ياسر يوم صفين:
نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله
( الاختصاص للمفيد ص 14).
ملامح المشروع الإصلاحي:
1) في السلطة وإدارة الحكم، وأهم وثيقة تركها في هذا المجال بعد تجربته الغنية هي عهده إلى مالك الأشتر، إنها تجربة الحاكم الذي يركن إلى الاستشارة "امخضوا الرأي مخض السقاية" "من شاور الرجال شاركها في عقولها"، ويدعو الأمة إلى ممارسة النقد للحاكم "فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة..".
2) في الاقتصاد، قدم نظريات هي بمثابة معادلات في الفكر العمراني والقتصادي، من قبيل مقالته لمالك الأشتر: "وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج فإنّ من استجلب الخراج من غير عمارة..." ومن معادلاته الهامة في الفكر الاقتصادي مقالته الشهيرة: "ما جاع فقير ألاّ بما مُتع به غني".
3) في الأخلاق والتربية، قدّم قواعد هامة من أهمها، القاعدة التي تنص على التفرقة بين المبادئ الثابتة والوسائل المتحركة: "لا تقسروا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم".
4) في الفكر والثقافة، فعلي(ع) هو أول من تحدث مندداً بالعقل المستقيل "نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل "، وإنّ سبات العقل واسترخاءه هو المنبت والمرتع الذي نشأت في سياقه كل حركات التكفير، لأنّ فوضى التكفير ناشئة عن فوضى التفكير، ولذلك كان علي(ع) يقول: "والله ما قصم ظهري إلا رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك.." إنّ الجاهل المتنسك يعيش حالة من الغرور الديني.
وتوضيح هذه الأبعاد وسواها يحتاج إلى متسع من الوقت نسأل الله التوفيق لذلك.
محاضرة ألقيت في مسجد الإمام الرضا (ع) في بئر العبد بمناسبة مولد الإمام علي (عليه السلام) 1435هـ.